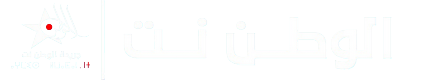لم حظي ريَّان بكل هذا التعاطف الدولي الإنساني؟
بقلم زهير اسليماني
لم حظي ريَّان بكل هذا التعاطف الدولي الإنساني؟ ألكونه طفلا؟ أم لكونه هوى في حفرة مستدقة سحيقة؟ لماذا توجهت إليه أفئدة العالم قبل أنظارهم؟ ولم هذا التعاطف إلى هذا الحد الشديد رغم ألاف الأطفال الضحايا.. ضحايا وحشية الحروب وضراوة الكوارث وفظاعة الجرائم؟!
لا شك أن تعرض أي طفل لأي كارثة، يشكل مأساة إنسانية بالنسبة إلى الإنسان السوي، لأن الطفولة برعم ندي، يتأثر أكثر من غيره من الفئات، بما قد يتعرض له من أزمات وكوارث وحوادث، فيؤثر على محيطه الإنساني والاجتماعي، عاطفيا وماديا.. وبمستويات مختلفة ومتباينة!
فإذا كان العالم أرق لريان فقط لكونه طفلا تعرض لحادثة مؤلمة، فلم لا يستيقظ الضمير الإنساني هذه اليقظة، إزاء المجازر الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، أو مذابح الأنظمة الشيعية العلوية الصفوية ضد أطفال السنة؟ وإزاء أية كارثة تحل بالأطفال من مجاعات وأوبئة وجوائح يروح ضحيتها أطفال أبرياء؟!
وإذا كان الأمر يتعلق بالواقعة وطبيعتها، أي بسقوط طفل بريء، بعمر خمس سنوات، في حفرة سحيقة، يتجاوز عمقها الثلاثين مترا، ولا يتعدى قرصها العشرين سنتمترا؟ هل تكون هذه المعطيات هي سبب التعاطف الإنسان الدولي، العابر للقارات والمعتقدات والجنسيات والعرقيات، إن نعم لم إذن؟! ألواقعة بعينها هي موئل التأثير أم امتداداتها الثقافية، وأبعادها الرمزية؟
قد لا يكون للإنسان -عموما- شبح أسود، يسكن مخياله ويرهق شعوره الجمعي، منذ حياته بالكهوف إلى خطوه على القمر، مثل شبح الأمكنة الضيقة المظلمة، ولعل لمواجهة ذلك، بنت الحضارات الإنسانية المتعاقبة، (الفراعنة، الآشوريين، الإنكا، الأزتيك، المايا..) مدافن فخمة وفسيحة، ومؤثثة بكل أنواع الأثاث بل بأفخر حتى مما في حياتها الدنيا من جهة، وسعت إلى بناء المدافن في مناطق عالية ومرتفعة من جهة أخرى، فقد ظل شبح القبوع في مكان سحيق وضيق ومظلم مصدر خشية، ومدعاة للخوف والرهبة والهلع لدى الكائن البشري..
فإذا كان هذا، شعور الإنسان البالغ، المستقوي، الفرعون، الإمبراطور، العالم، البابا، القس، الراهب، المؤمن، المرسل، الصحابي.. فلابد أن يكون الأمر أشد في المخيال الجمعي للإنسان العادي، بمختلف تلاوينه الثقافية، فالسقوط في حفرة بهذا القطر الضيق، وهذا العمق السحيق ليس في حد ذاته، ما يثير كل هذا التسونامي الانفعالي لدى الانسان الموجود خارج الحفرة، بل ما يثيره من دلالات ويصوره من مشاهد ويحركه من خيال، وصور تسكن الذات وتترسب في أعماقها، وتتراكم في مخزونها الثقافي وتجربتها الوجودية، حول وحشة الموت وظلمة القبر وحياة البرزخ.. (آلهة الحساب وحوش العذاب، سربروس، الأقرع الشجاع، الثعبان..)
إن ما أيقظ الضمير الإنساني في هذه الواقعة، ودغدغ الإنسان الراقد والانسانية الراكدة في أعماقنا. والمحنطة بفعل إكراهات اليومي من جهة، والتعود على المآسي الإنسانية من جهة أخرى. هو الشبح الأسود القابع في كياننا والمترسب في لا شعورنا، وهو الخوف من الموت، ليس لأنه انتقال من لحظة زمنية إلى أخرى، بل لأنه نقل من فضاءات الفساحة والرحابة، إلى أجواء الضيق والوحشة. ولعل حدث “ضمة القبر” والآثار الواردة عنه، والترجمات التصورية له، أي بأبعاد الواقعة الرمزية وإمكاناتها الدلالية وصورها الثقافية، لا بحدودها المادية الواقعية، طفل وحفرة وظلمة.. إن ما حرك الشعور الإنساني، في هذه الواقعة، هو الإسقاط والتركيب الثقافي للأبعاد الرمزية الإيحائية لهذه الواقعة، فرمزيتها الموغلة في الرعب، ودلالتها المستغرقة في الغموض، وما تحركه من استهامات، وتبنيه من صور، وتطرحه من أسئلة حارقة؛ ماذا يحدث هناك ليس لريان كواقعة؟ بل لأي إنسان هوى في مثل هذا الضيق، وهذا العمق، وهذه الظلمة والوحشة؟ كمصير متوقع ومشترك لا محيد عنه!
إنه مصيرنا المؤجل، مآلنا المنتظر، خوفنا المشترك، كياننا الهش، حقيقتنا التي منها جئنا؛ ضيق وظلمة الأرحام، وإليها سنصير؛ ضيق وظلمة القبر، وما بينهما ليس إلا تلهيا وتلبسا لهذه الحقيقة بلبوس زخرف الحياة الدنيا. فليس ريَّان في عمق وضيق الحفرة، إلا نسخة محققة لنموذج عام ومشترك يركن عميقا فينا، ويمثل الشبح الأسود لوجودنا، رجته هذه الواقعة رجة أقوى.. فأيقظته من غفوته على آرائك المادية وسرر الأنانية، وفرش السلطة، وأعادته لحالته الأولى؛ حالة العماء، بين الظلمة الأزلية المريحة (الأرحام) وذلك ما تدل عليه تصورات البعض بأنه كان يمص سبابته، والظلمة المصيرية المخيفة (القبر)، التي دلت عليها ممارسات البعض الصلوات والتعاويذ والأدعية والشعائر المختلفة.. محاولة (هذه التصورات) تقرير معنى لما يمثل أمام عين تحاول انتقاء ما يشبع آمالها ونفي ما يثير مخاوفها، ولو خلافا للواقع وعلى حساب موضوعيته!
(مع آخر سطر من هذه المقالة، تلقيت النبأ المفجع، رحم الله الملاك الريان، لن ننساه ما حيينا)